صعلوك في عاصمة الضباب: لا تبرد ثاراتنا حتى في شارع اكسفورد وبين ساقين كالرخام الأملس
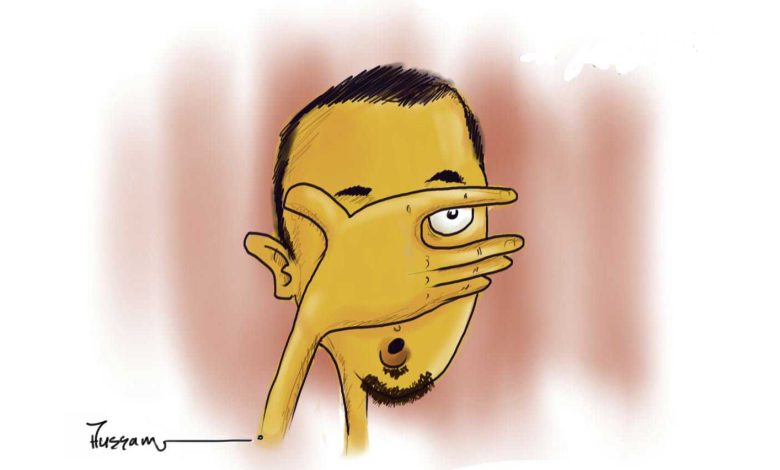
سكبها لكم الدبور السوداني: محمد مبارك
الإحساس بالمرأة معناها إحساس بالوجود.. بالبحار والألوان والعصافير، وبالرغم من تلك الجماليات فهناك شيء لا مرئي داخل أي امرأة.. شيء غامض.. غموض السياسة العربية وموقفها تجاه ما يحدث في فلسطين. وقد حاولت مرارا اكتشاف ذلك الغموض بإقامة علاقات متعددة مع نساء مختلفات، أو امرأة واحدة حتى لو كانت تحمل تقاطيع وجه روبرت موغابي وخفة دم صدام حسين! وليس هدفي المرأة في حد ذاتها، فهذا أمر لا يشغل بالي إنما الهدف الاستراتيجي هو اكتشاف المنطقة الضبابية داخل المرأة لعلمي أن هذه الضبابية هي القاسم المشترك بين كل بنات حواء، وقد أصبت بانشطار داخلي نتج عنه عقدة اسمها المرأة!! وأخذت أبحث في الأزقة العربية عن أحد تلاميذ فرويد لمساعدتي في حل تلك العقدة الأزلية، وقد نصحني بعض النصحاء أن لا أضيع الوقت لأن كل أطباء علم النفس محتكرون من قبل الحكام العرب!!
في صدر شبابي وجاهليتي الأولى (هناك جاهلية ثانية!) سافرت إلى لندن عاصمة الضباب (ألا تلاحظون أن كلمة الضباب مرادفة لكلمة الغموض!) وكانت أمنيتي في حياتي أن أقيم علاقة مع امرأة سكسونية من آل سكسون الذين استعمروا السودان أكثر من قرن، ولم أكن أدري وهذا من (السذاجة) أن الدخول في علاقة مع امرأة من هذا النوع المعدوم في مضارب بني يعرب يتطلب معطيات خاصة ومهارات فريدة لا يدخل من ضمنها الشعر النبطي أو اللبطي! والجيب المنتفخ هو أول تلك المعطيات، أما المهارات تنحصر في خفة الحركة وأن تكون لماحاً فطنا، تحمل في أجفانك عينين مثل عيني زرقاء اليمامة لا تلتقط إلا النساء ذوات الثدي! وأن تكون حافظا بعض الكلمات والتعابير الراسبوتينية التي تجعل المرأة تسقط من عل كجلمود صخر!! لإذابة البرود الإنجليزي.
وبما أنني ويا للحسافة فإن مهاراتي تنحصر في المهاترات السياسية ولغو الحديث والمناكفة المتعمدة للرأي الآخر والنميمة العربية، ولو وجدت فرصة لغزوت منزل جاري واحتللته واستبحت زوجته وجاري هذا سيكون أول الهاربين ليبحث عن (أزعر) لمساعدته في استعادة زوجته ومنزله!!
ولكني تذكرت أنني أحمل الجينات الأفريقية واعتمدت على حمية الغابة كخط دفاع أو هجوم أخي! ومعروفا عن هذه الحمية أنها تذوب الجليد من على قمة الألب وجبال الهمالايا، وأن الفحولة الإفريقية هي جواز المرور دون شك إلي مخدع أقوى امرأة بريطانية حتى لو كانت مارجريت تاتشر (اسألوا إخواننا النيجيريين!! وأهل مكة أدرى بشعابها!)
وقتها وأنا أتسكع في ساحة بيكدلي سيركس وشارع اكسفورد كنت أستعرض نفسي لتتحرش بي واحدة من ذوات الشعر الأصفر والعيون الزرق (عقدة!) وكنت من طرف خفي أنظر إلى أي أنثى مارة أمامي لأرى ردة فعلها أمام تلك الفحولة الأفريقية، وأنا منتفخ الأوداج. . ولكن هيهات بالرغم أنني كنت أردد أغنية عبد الحليم حافظ (سواح وأنا ماشي في البلاد سواح) في انتظار (الفرج) ليفتح لي أبواب الليالي الأندلسية مع إحدى نساء الفرنجة لأعمل في ساحاتها الجسدية مثل ما عمله أجدادها عندما استعمروا السودان ولكن لا حياة لمن تنادي!
وركبني اليأس كيف أرجع إلى الخرطوم دون أن أستبيح الشرف الإنجليزي؟ ولا أحمل ما يؤكد أن غزوتي للشرف الرفيع قد نجحت؟ وماذا يقول عني أهل أمدرمان (وهم الذين يعرفونها طايرة) يا للفضيحة!!
إن رجوعي دون برهان ساطع سيجعل حتى المرأة السودانية تنظر لي شذرا واحتقارا!! ناهيك عن هؤلاء الخناشير (قاتلني الله لو كنت أعرف معنى هذه الكلمة) وفي انتظاري على أحر من الجمر لرؤية المنديل الذي كان أكثر بياضا من دشداشة خليجية وقد أصبح أحمرا من فعل الدم المسفوح داخل ردهات قصر باكنجهام وعلى عقارب ساعة بنج بنج!!
يا لها من هزيمة، ألا تكفي الهزائم العربية عبر التاريخ التي حولت الأكاذيب إلى حقائق وأصبح التاريخ قوادا والمهرج سلطانا؟!
وفجأة وأنا في خضم هذه الدوامة مرت أمامي امرأة شاهقة الجمال ساقيها مثل العاج المخروط، وصدرها ينم عن رحابة لا حدود لها! عيناها مثل البحر الذي لا سواحل له! ولونها لو رأته ألوان الطيف لانزاحت خجلا! وتلك اللحظة أدركت لماذا قتل هابيل قابيل (أو العكس) لا بد أنهما كانا افريقيان!
وبما أنني أنتمي إلى مجتمع ذكوري استيقظت في داخلي كوامن الذكورة البدائية فقررت أن أثأر للكرامة العربية من مسلسل الهزائم خاصة فلسطين المختلة (آسف المحتلة) ومشيت وراء تلك المرأة الأسطورة وفي يقيني أنها حفيدة بلفور صاحب الوعد المشهور ولكن كيف ومن أين أبدأ الحديث معها وهي متداخلة الألوان وأنا ذو لون واحد ضارب في السواد وأي ذعر سوف يجتاحها عندما ترى وجهي؟ ولكن تذكرت مقولة ابن عمي عنترة العبسي (لولا سواد الليل ما طلع الفجر) الله يبشبش الطوبة اللي تحت دماغك يا بن عمي، لقد ساعدتني في خلخلة الحاجز النفسي والثقافي بيني وبين حفيدة بلفور!
وعلى طريقة أنني سائح أجنبي طلبت منها المساعدة في معرفة معالم لندن السياحية، لكنها لم تفاجأ بطلبي هذا لأنها (متعودة دايماً!) على تلك الأسئلة السخيفة من العربان الذين تعج بهم شوارع لندن وأنديتها الليلية، وقالت لي ونظراتها تمسحني من أعلى إلى أسفل اذهب إلى مكتب (الانفورميشن!) . في تلك اللحظة شعرت بهزيمة لا تعادلها هزيمة 67 ، وقررت الرجوع إلى السودان أو إلى أي دولة عربية حتى لا أتعرض لمحكمة وسخرية المجتمع، لأن أكبر الانتصارات في المفهوم العربي أن تغزو جسد امرأة أوروبية أو أمريكية طالما انهم غزو الأرض العربية بإقامة قواعد عسكرية لحمايتها من بطل أم المعارك!!
الجيوش البريطانية عندما خرجت مذلولة من مستعمراتها الأفريقية والعربية لم يتركوا أي بصمات على تلك الشعوب عكس الاستعمار الفرنسي الذي عندما خرج من الدول المغاربية خرج كآلة عسكرية ولكنه خلف وراءه الاستعمار الاستيطاني من ثقافة ولغة واقتصاد ودعارة أيضا! ولذلك نجد أن الشعوب المغاربية أكثر التصاقا بفرنسا وثقافتها من ارتباطهم بدول وشعوب المشرق العربي، واللغة الفرنسية في المغرب العربي هي لغة التخاطب اليومية. . لغة الشارع، وأدى ذلك الواقع إلى اضمحلال اللغة العربية.
واللغة الفرنسية لغة مدهشة. . ناعمة ودلوعة! خاصة عندما تتحدث بها امرأة فرنسية أبا عن جد بيضاء (ملظلظة) ليس سنغالية مولودة في باريس!!
عندما ذهبت إلى باريس بالصدفة لم أكن أعرف غير شارع الشانزيليزيه ومتحف اللوفر وبرج ايفل وذلك من خلال المعلومات الجغرافية ، وكان من ضمن أحلامي البرجوازية أن أزور باريس، ولو خيروني بأن أنام في أحضان امرأة عربية أو أسافر إلى باريس لاخترت الثانية بكل تأكيد، والسبب في ذلك مع احترامي للمرأة العربية أن زيارة باريس تزيدني معرفة ومتعة وثقافة.. والمرأة العربية تسلبني كل تلك الأشياء بل تزيدني جهلا!!
عندما وصلت إلى باريس ذات مساء ناعم يتخلله رذاذ من المطر الخفيف ، كانت أضواء الشوارع ناعسة تبعث في داخلك الراحة والطمأنينة، أخذني صديقي السوداني الذي يتكلم اللغة الفرنسية بلكنة قبيلة الدناقلة في شمال السودان وفي غمرة ذلك الحلم المستفيق وصلنا إلى قلب المدينة التي تجمع في أحضانها الجمال والحرية المطلقة، وشوارعها أنظف من الفكر العربي ، وتذكرت شوارع الخرطوم التي لا لون ولا طعم ولا رائحة! (لاحظوا اللاءات الثلاث!) تذكرك بلاءات لا تفاوض لا صلح لا اعتراف!!ّ أين تلك اللاءات الآن؟ لقد تفاوضنا وتصالحنا واعترفنا. . وما شأني أنا؟ بلا خيبة!!
دخلنا إحدى المقاهي التي تنتشر على جانبي الشانزيليزيه (آل استار كافي آل!) رائحة المكان خليط من دخان السجائر والنبيذ والنساء! وموسيقى هادئة تنبعث من إحدى الزوايا، والحوار بين الحضور يدور في همس ملفت للنظر وكأنهم يتناجون الغرام تحت الأضواء الخافتة، في تلك اللحظات تذكرت ذلك اللقاء الذي جمع بين أبي الطيب المتنبي والفرزدق وأبي نواس في ذات المكان منذ سنوات، وخيبة الأمل التي أصابتهم من عدم قدرتهم على التأقلم مع الأجواء الرومانسية الحالمة التي تتميز بها باريس، وقد قرروا الرحيل فورا خوفا من تعرض الشرف العربي والكرامة العربية للامتهان من حسناوات المدينة!!
جال نظري في أركان المكان فرأيت إحداهن تجلس وحيدة تحت ضوء يتسلط فقط على عينيها وشفتيها ولم أر باقي الامتداد الجسدي ولكن قد تخيلته! اقتربت منها في حالة تردد ورغبة ووقفت أنظر إلى عينيها.. ابتسمت وقالت كلاما بالفرنسية فهمت (يا للفهلوة) أنها تدعوني للجلوس! مع أنني لا أفهم ولا أعرف في اللغة الفرنسية غير كلمة (مرسي) مثل مندوب اليمن في الأمم المتحدة على أيام طيب الذكر الإمام أحمد بن حميد الدين لا يعرف سوى (يس و نو) !! جلست على أطرافي. . تعمقت في لهيب عينيها وهي تنفث دخان سيجارتها من بين شفتيها .. وشفتاها مثل فاكهة محرمة لا بد من أكلها (تعلمنا أكل التفاح المحرم من الوالد العزيز آدم بعد المؤامرة النسائية وخرج بعدها ولم يعد!!)
عرفت أنني أجنبي ينشد الراحة في المدينة، ولم أشأ أن أخبرها بأني حامل جينات إفريقية عربية! حتى لا تصدم وتتراجع من الحديث معي، وابتسمت وسألتني بلغة لا تحتاج إلى جهد لفهمها: من أين أنت؟ تصببت عرقا.. هل أقول لها أنا من السودان أم من السويد؟! قالت: أأنت إفريقيا؟ رددت عليها وقلت: ومن نيجيريا أيضا!! تأملتني وكأنها في حالة اكتشاف شيء جديد وقالت: (.. ما أروع لونك الأسود، لون السحر والغموض والأعمال الفاضحة!!) باختصار رحت في غيبوبة.. مثل هذا الكلام لا تقوله أي امرأة عربية حتى لو كانت محششة!!
ولعمري لم ألتق بامرأة عربية أستطيع أن أطلق عليها اسم امرأة أنثى، وهي امرأة مجازا بحكم أنها ترتدي الملابس النسائية وتعتبر بيولوجيا من فصيلة الثدييات خاصة بعد الزواج والإنجاب فتصبح لجة من الشحم واللحم المشبع بالكوليسترول.. فانك لا تعرف إذا ما كنت مقبلة أم مدبرة!! وصلاحيتها تنتهي بعد الولادة الثانية أو الثالثة على أبعد تقدير، ويبدأ هروب الزوج إلى المقاهي بعد أن يدرك أن الذي تقاسمه حياته ليست أنثى إنما فرس بحر!!!






